الخيار بين المشروع الإيراني والمشروع الأميركي في العراق والمنطقة
الصراع بين المشروعين الإيراني والأميركي في المنطقة هو صراع رجعي بامتياز، صراع من أجل الهيمنة الاقتصادية والسياسية كانت إسرائيل وما زالت تلعب رأس حربة أميركا في المنطقة.
إن الخيار بين المشروع الإيراني والمشروع الأميركي في المنطقة، وخاصة في العراق، هو الخيار بين الكوليرا والطاعون، عندما وصفنا الخيار بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في الانتخابات الأميركية عام 2015.
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي تحدث قبل أيام بأن إيران أفشلت المخطط أو المشروع الأميركي في المنطقة. كان يقصد بشكل خبيث كي تتسيد البورجوازية القومية الإيرانية المنطقة. ولكن ما هو المشروع الإيراني البديل الذي أحله خامنئي محل المشروع الأميركي؟
الحرب الوحشية المستعرة والتي تقودها إسرائيل في غزة أسقطت الرتوش ومزقت الأقنعة التي كان يلبسها الجميع في مسرحية طالت مشاهدها وفصولها، وظلوا يرسمون صورة كاذبة ومخادعة عن وجودهم بعناوين سياسية مختلفة، واحدة كانت باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والثانية باسم المقاومة والممانعة أو مقارعة الاستكبار العالمي أو الامبريالية، والناتج الحاصل بينهما هو الحروب والاغتيالات والفقر والجوع والسجون والمعتقلات والتهجير.
الصراع بين المشروعين الإيراني والأميركي في المنطقة هو صراع رجعي بامتياز، صراع من أجل الهيمنة الاقتصادية والسياسية، وكانت وما زالت تلعب إسرائيل رأس حربة أميركا في المنطقة كما تمثل الميليشيات الممولة من إيران ذراعا ضاربة لها.
الولايات المتحدة فضلا على عسكرتاريتها، فهي تستخدم أدواتها الأخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مجلس الأمن والأمم المتحدة وسيطرتها على المفاصل المالية والاقتصادية في العالم من أجل إخضاع منافسيها لسيطرتها السياسية، بينما لا تملك إيران غير الاستثمار السياسي والعسكري في الدول الفاشلة، كما نراها في العراق ولبنان واليمن وسوريا. العناوين السياسية التي يستخدمها المشروع الإيراني أو المشروع الأميركي هي عناوين للتضليل وإخفاء ماهية هيمنتها الاقتصادية والسياسية، وما يحدث اليوم في المنطقة بيّن زيف تلك العناوين.
بيّنت التجربة العملية وعلى أرض الواقع أن المشروع الأميركي في المنطقة لم يكن أبدا مشروعا من أجل تأسيس أيّ نظام علماني وديمقراطي في أيّ بلد، وعلى العكس تماما، فإن المشروع الأميركي خلف نهوض وتقوية كل التيارات الإسلامية والرجعية في المنطقة، بدءا بتعويم الخميني ودعمه والالتفاف على الثورة الإيرانية عام 1979 ونقله إلى طهران من باريس على متن الخطوط الجوية الفرنسية وفتح القنوات الإذاعية لخطبه مثل صوت أميركا والبي بي سي ومونت كارلو، ومرورا بتجنيد الشباب في المنطقة وإرسالهم إلى القتال في صفوف المعارضين الأفغان للاحتلال السوفييتي عام 1979 تحت عنوان محاربة الإلحاد الشيوعي والكفر، وتحول السفير الأميركي في القاهرة في الثمانينات من القرن الماضي إلى أكبر داعية للتجنيد في المنطقة، وانتهاء بتنصيب الأحزاب الإسلامية على السلطة في العراق بعد غزوه واحتلاله والتي تتبجح اليوم بكل صلافة بعنوان المقاومة والممانعة، إلى جانب دعم الإخوان المسلمين في مصر وتونس وكل الجماعات الإسلامية بعد ما سمّي بالربيع العربي في سوريا والمنطقة، وكان بما فيها عقد الجلسات والاجتماعات بين ممثلي الكونغرس الأميركي وعلى رأسهم المرشح الرئاسي جون مكين في سوريا عام 2012 مع أبوبكر البغدادي وقادة داعش الذين اغتالتهم القوات الأميركية للالتفاف أيضا على الثورتين التونسية والمصرية والتصدي لهبوب نسيمهما في المنطقة.
وقد بينت انتفاضة أكتوبر عام 2019 في العراق أن السياسة الغربية بما فيها أميركا لم تبال بكل عمليات التصفيات والاغتيالات التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين الذين بلغ عددهم أكثر من 800 شابة وشاب إضافة إلى أكثر من 20 ألف جريح، فهي لم تحرك ساكنا عبر فرض العقوبات الاقتصادية على قادة الميليشيات وحكومة عادل عبدالمهدي التي لقبت بحكومة القناصين الملطخة أياديها بدماء المتظاهرين بل على العكس تماما ساعدت الأحزاب الإسلامية سياسيا ومعنويا في عبور الأزمة التي أحدثتها انتفاضة أكتوبر في السلطة السياسية، في حين تكشف حرب غزة نفاق السياسة الأميركية، فعندما تتعرض قواعدها للقصف أو تصل أسلحة إلى حزب الله عبر شركة “فلاي بغداد” على سبيل المثال تفرض العقوبات الاقتصادية عليها وعلى قادة تلك الميليشيات.
أما المشروع الإيراني كما تحدثنا هو الاستثمار في الدول الفاشلة أو في البلدان التي تنعدم فيها أيّ أسس للدولة بالمعنى القانوني والهوياتي والأمني والسياسي، وإذا كانت الحرب تعبيرا مكثفا عن الاقتصاد، فإيران دولة غير قادرة على المنافسة الاقتصادية في السوق الرأسمالية في المنطقة دون ميليشيات وقوة عسكرية، أي أنها لا تملك الأموال بسبب العقوبات الغربية عليها ولا تملك التكنولوجيا الصناعية التي تؤهلها للمنافسة الاقتصادية.
وعليه على سبيل المثال لا الحصر، ليست هناك منافسة اقتصادية عادلة بين السلع التركية والإيرانية في السوق العراقية. فالأولى تتفوق على الأخيرة بكل المعايير، إلا أن الثانية تهيمن على السوق العراقية في المدن الجنوبية وبغداد، وهذا يتم عن طريق الميليشيات التابعة لإيران حيث تلوي عنق الأسواق المحلية أو تدوير رؤوس أموالها التي تهرب من العراق عبر أدواتها إلى إيران أو إعادة تدوير رؤوس الأموال التي تمول ميليشياتها.
وهكذا بالنسبة إلى التحرش الحوثي وإبراز القوة في البحر الأحمر، فليست له علاقة لا من بعيد ولا من قريب بـ”نصرة الشعب الفلسطيني”، إنما هو بعث عدة رسائل أولها يجب الاعتراف بالحوثيين كقوة موجودة في المعادلة السياسية اليمنية والتفاوض معها وليس مع الحكومة التي لها مقعد في الأمم المتحدة وتعترف بها حكومات العالم، والثانية طمس كل الأوضاع المأساوية التي تمر بها الجماهير الواقعة تحت سلطة الحوثيين من الفقر وقمع الحريات والفساد. وكتحصيل حاصل تستفيد إيران بأن تقول إنها تستطيع التحكم بجزء من عصب الاقتصاد العالمي عبر الحوثيين.
وبنفس السياق يقصف الحرس الثوري مدينة أربيل، فعندما فشلت الميليشيات التابعة لطهران في العراق من ردع القوات الأميركية في العراق أو ما ستذهب إليها في المنطقة، قامت بضرب مدينة أربيل لاستعراض القوة، وجاءت بعد هجمات القوات البريطانية – الأميركية على الحوثيين.
أي بمعنى آخر إن التضامن مع الشعب الفلسطيني هو يافطة تختبئ الميليشيات المجرمة خلفها، والجدير بالذكر أن انضمام ميليشيات الحشد الشعبي في العراق إلى “محور المقاومة والممانعة” أو تعليق يافطتها في قنواتها الفضائية وعلى جدران مقراتها جاء متأخرا جدا وتحديدا خلال أيام انتفاضة أكتوبر 2019 عندما طالب الملايين من المنتفضين بمحاكمة الفاسدين في الأحزاب الإسلامية وضمان بطالة وفرص عمل وتوفير الخدمات وتحقيق المساواة، وكي تبرر تلك الميليشيات حملتها الوحشية للقضاء على الانتفاضة وإضفاء الشرعية على قتل المتظاهرين بدم بارد رفعت يافطة محور المقاومة والممانعة على دكاكينها الممولة من سرقة ونهب ثروات جماهير العراق.
إن النقطة الجوهرية التي نود الإشارة إليها، هي الأوهام التي تنشرها القوى المؤيدة لأميركا أو المتوهمين حقا بالسياسة الأميركية، وهي أن انسحاب أميركا من العراق يعني أن الاحتلال الإيراني سيحل محلها، وفي الحقيقة هو جزء من الوهم والعزف على الوتر القومي المشروخ وبشكل أحادي. والسؤال الذي يجب أن نطرحه ماذا جنت جماهير العراق من الوجود الأميركي في العراق؟ إن القوميين الذين يحملون نزعة معادية لما يسمى بالعدو الفارسي هم من يروجون لهذه الأوهام، واستغلت أميركا تلك الأوهام لإدامة حرب ضروس دامت ثماني سنوات 1980 – 1988 (الحرب العراقية – الإيرانية)، والتي قتل فيها أكثر من مليون شخص إضافة إلى تدمير مقدرات المجتمع، وتحت عنوان حماية البوابة الشرقية للأمة العربية.
وخلال كل الوجود الأميركي سواء كان على شكل غزو واحتلال العراق أو على شكل تواجده بعد اجتياح داعش لثلث مساحة العراق، كانت السياسة الأميركية فعالة من أجل تقوية نفوذ الجمهورية الإسلامية. وكان كلا المشروعين دعامة صلبة لإدارة أزمة السلطة السياسية في العراق.
إن كل عمليات الفساد والإجرام والفقر والاغتيالات والسجون السرية وقانون مادة أربعة إرهاب وقوانين رجعية أخرى مناهضة للنساء وحقوق الإنسان وتحويل العراق إلى حديقة خلفية للجمهورية الإسلامية تجري وتترسخ عبر دعم السياسة الأميركية. لأن ما يهم مصالح الولايات المتحدة أن يكون العراق سوقا للعمالة الرخيصة وتسن فيه قوانين استثمار لها جاذبية في جلب رأس المال، وحماية مكانة العراق كمنتج للنفط في السوق الرأسمالية العالمية، وأن لا تؤثر على إزعاج صفو حركة الرأسمال في المنطقة، وأي شيء غير ذلك فهو هراء من وجهة نظر المصالح الأميركية. وبالنسبة إلى إيران تبحث لها من خلال هذه الأوضاع عن مكانة لها، وما عدا ذلك فلا شأن لها بها.
إن حرب غزة بينت أن جماهير المنطقة ليس أمامها إذا أرادت أن تعيش في بر الأمان والحصول على قوتها وقوت أطفالها والعيش في ظل الحرية والتمتع بثرواتها إلا إفشال المشروعين في المنطقة أو مكافحة الكوليرا والطاعون.
المصدر: صحيفة العرب

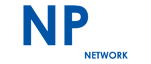

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.